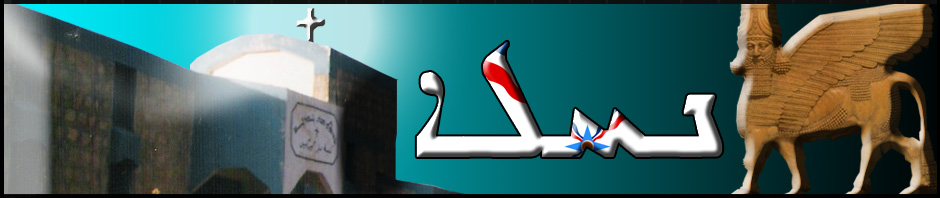بقلم فواد الكنجي
الموضوع; في يوم العالمي لحقوق الإنسان.. الإنسان بلا حقوق
13 / 12 / 2021
http://nala4u.com
يحتفل العالم كل عام في العاشر من كانون الأول باليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ بعد إن تم في هذا اليوم الإقرار عن (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) من قبل (الجمعية العامة للأمم المتحدة) عام 1948، الذي يعتبر بكل المقاييس الحقوقية أهم وثيقة من الوثائق الدولية في مجال حقوق الإنسان .
وطوال العقود الماضية وتبعا لما ورد في لائحة حقوق الإنسان وبما تم عقد اتفاقيات ومعاهدات دولية لتعزيز من حقوق الإنسان الأساسية إلا إننا التمسنا في إنحاء العالم؛ الكثير من الدول تتراجع عن هذه الحقوق تحت ذرائع وحجج لا أول لها ولا أخر؛ وللأسف نقولها.. لم تتمكن المنظمة الدولية ما يجب عليها من الواجبات لقيام بدورها الإنساني لاستعادة الأمن والسلم المجتمعي والحفاظ على حقوق الإنسان ودعمها وتنميتها؛ بقدر ما احتسب عليها من إخفاق وتراجع؛ إن لم نقل بان حقوق الإنسان في عديد من مناطق العالم تدهورت لدرجة التي تركت جروحا ومأساة لا يمكن للبشرية نسيانها؛ حيث ارتكبت العديد من جرائم الإبادة الجماعية هنا وهناك.. في وقت الذي تجاهلت (الأمم المتحدة) وفشلت في التدخل لنجدة نداءات هؤلاء الإفراد والجماعات والأقوام الذين تعرضوا للإبادة الجماعية، وقد دفع الكثير من هذه الأقليات والشعوب؛ ثمنا باهظا بما تعرضوا للانتهاكات ممنهجة وخطيرة لحقوق الإنسان؛ وعلى كل مستويات الحياة في التعليم.. والصحة.. والغذاء.. وحرية الاعتقاد.. والعبادة.. والتنقل، بل إننا نجد بان (الأمم المتحدة) هي ذاتها تصدر قرارات جائرة بفرض عقوبات اقتصادية على بعض من شعوب العالم؛ كما فعلت عام 1990 بحق الشعب (العراقي) ليموت أكثر من مليوني طفل بسبب نقص الدواء والغذاء نتيجة التطبيق الصارم لقرارات مجلس الأمن دون أي اعتبار عن الآثار الإنسانية المروعة التي خلفها هذا القرار، وان (الأمم المتحدة) أيضا لم تفعل شيئا اتجاه الغزو (الأمريكي) وحلفاؤها ضد (العراق)؛ والذي جاء كأكبر انتهاك للقانون الدولي ولميثاق (الأمم المتحدة) ولاتفاقيات (جنيف) و(لاهاي).
ومثل هكذا قرارات اتخذ ويتخذ إلى يومنا هذا بحق الشعب (الفلسطينيين) ليلاقوا الذال.. والمعاناة.. والجوع.. والمرض.. والتشرد.. والتهجير ألقسري.. والنزوح في المخيمات.. دون إن تراعي (الأمم المتحدة) ما أقرته في (إعلان العالمي حقوق الإنسان)، وكذلك فشلت (الأمم المتحدة) في منع حدوث الأزمة الإنسانية في (سوريا) و(اليمن) ودول عربية أخرى، لنجد عبر كل هذه الماسي التي تحدث بحق حقوق الإنسان؛ تقف (الأمم المتحدة) ومنظمات حقوق الإنسان عاجزة من إنقاذ وفعل واجبها الإنساني في حماية حقوق الإنسان من الاضطهاد والتعسف في مناطق النزاعات الكبرى، لذا فان الكثير من النازحين واللاجئين والمهجرين في (العراق) و(فلسطين) و(سوريا) و(اليمن)؛ وجدوا أنفسهم بلا مأوى؛ بعد إن تركوا ديارهم قسرا وبلا جهة تتولى حمايتهم، لنلتمس حجم تراجع الملحوظ والتجاهل في حماية ومناصرة حالات حقوق الإنسان في العالم؛ ناهيك عن تجاهل (الأمم المتحدة) ومنظمات حقوق الإنسان عن حالات التعذيب.. والاعتقال التعسفي.. والاختفاء ألقسري.. والاستجواب تحت التعذيب غير قانونية.. والمحاكمات الجائرة التي تحدث في العديد من دول العالم، وهنا من حقنا أن نسال:
أليس من واجب (الأمم المتحدة) وقف مثل هذه الانتهاكات والإجراءات الصارمة بحق الأبرياء……………؟
نعم.. إن حالة حقوق الإنسان ليست على ما يرام؛ نتيجة تعامل (الأمم المتحدة) بازدواجية المعايير في معالجة مشاكل حقوق الإنسان؛ ودوما تبحث عن حلول قصيرة المدى؛ ولا تعالج أساس المشكلة وجذورها خاصة مع بلدان العالم الثالث؛ وتتجاهل التعاون مع المنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان؛ فهي لا توجه جهودها للنهوض بحقوق الإنسان بقدر ما تستغل هذه المشاكل للتدخل السياسي، لأننا نجد الكثير من الدول المتقدمة وخاصة (الرأسمالية) والتي تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون؛ ولأكن نجدها في وقت ذاته ترتكب أبشع الفظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان وعلى نطاق واسع وعلى مستوى التدخلات العسكرية.. والاحتلال.. وإسقاط الأنظمة الوطنية بقوة السلاح والغزو وبدون وجه حق.. والى غير ذلك؛ من قضايا التمييز العنصرية.. والتهميش الأقليات.
ومن هذه الحقائق التي نلتمسها على ارض الواقع؛ فلابد إن أرادت (الأمم المتحدة) النهوض بمهامها الدولي في حقوق الإنسان؛ فعليها إن تضع آلية تقييم شفافة لقراراتها ومتابعة تنفيذها بفعالة جادة وبالمساواة مع جميع دول العالم دون استثناء لمنع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان؛ والعمل على مكافحة الإفلات من العقاب بكل ما أتى لها من قوة، بعد إن يتم التنسيق وعلى مستوى عالي من المسؤولية لتحسين العمل والتنسيق بين الهيئات والمنظمات الغير الحكومية وأجهزة الدول مع (الأمم المتحدة) لوضع آليات عمل جاد لتعيد لـ(الأمم المتحدة) دورها وما ينبغي العمل وبروح من التضامن والعمل المشترك لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لجميع الضحايا من الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان، لان عالمنا اليوم في ظل صعود نظم دكتاتورية وأحزاب دينية مسيسة وراديكالية إلى سدة الحكم والتي تقمع الحقوق والحريات وتكمم أفواه الصحافة والإعلام الحر، وتمنع عمل المنظمات المجتمع المدني التي تنادي بحقوق المواطنة.. وقيم الحرية.. والعدالة الاجتماعية.. والكرامة.. وحقوق الإنسان، فهذه الأنظمة الشمولية القمعية؛ ونضرا لاستشراء الفساد في آليات حكمهم في إدارة شؤون البلدان التي يديرونها سواء عبر زعماء فاشستيين.. أو أحزاب سياسية دينية راديكالية.. أو ميلشيات مسلحة؛ يشكلون تهديدا حقيقيا لقدرة المجتمعات لتحقيق العدالة والمساواة لتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لنجد في ظل هذه البيئة الملغومة تنامي الحركات العنصرية والتطرف الديني والمذهبي والقومي بما تفرزه من مشاعر الكراهية والتعصب والتطرف في المجتمعات؛ الأمر الذي يفاقم من حالات العنف ضد الأقليات القومية.. والدينية.. والعرقية.. والمهاجرين.. في العديد من بلدان العالم الثالث؛ بكون هذه النظم يغيب عنها القانون والإطار التشريعي الذي يضمن المساواة.. والعدل.. وحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع؛ لان النظم القمعية الدكتاتورية لا تؤمن بالتنوع الثقافي.. والاجتماعي.. والعرقي.. والديني، ومع ذلك نجد بان هذه النظم تلجئ لتلميع وجهها القبيح بوسائل ديمقراطية زائفة؛ منها إصدار بعض القوانين وكأنها ورقة إصلاحية وبما يناسب سياسة حكامها ولإبعاد من يريدون إبعاده عن الساحة السياسية وكأسلوب لخداع المجتمع؛ وكذلك يقومون بمنح وبقدر محدود حريات لوسائل الإعلام لجس النبض مشاعر المجتمع وما يفكر به؛ كما أنهم يحاولون استخدام الانتخابات لإقناع الشعب بأن أنظمتهم ديمقراطية؛ ولكن في الباطن يستخدمون كل وسائل التزوير لضمان إبعاد المعارضة لعدم حصول أصوات كافية لانتخابهم .
وهذه الأساليب تستخدمها الأنظمة الشمولية.. والسلطوية.. والدكتاتورية.. لتحكم بالمنظومة السياسة.. والاقتصادية.. والاجتماعية في الدولة، ولكن للأسف نشاهد في الكثير من البلدان المعاصرة الديمقراطية؛ يتحولون إلى نظم دكتاتورية؛ وخاصة في البلدان التي مازلت (الأمية) حاضرة في مجتمعاتها وبدرجة كبيرة؛ ويعاني المجتمع من مظاهر متخلفة اجتماعيا.. وتربويا.. وتعليميا.. وثقافية.. لا حصر لها؛ وعلى كل مستويات ومناحي الحياة وطبقات المجتمع؛ وبما يعاني المجتمع من مظاهر المد العشائري وبأساليب وسلوكيات وتركيبات ملئها بالأعراف والتقاليد لدرج طغيان هذه الأساليب على النظم الاجتماعية والسياسية، ليكون مجتمعاتها مشتتة الانتماءات والولاءات؛ بكون هذه المجتمعات تعاني معاناة حقيقية في تراجع مستوى الوعي.. والإدراك.. والتطور الفكري.. والثقافي؛ فيبقوا ضمن هذا الإطار المتخلف بعيدين كل البعد عن مفهوم الديمقراطية الحقيقية؛ بقدر ما يفهمون من الديمقراطية بشكلها السطحي؛ باعتبارها تداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع؛ في وقت الذي يغرق المجتمع بتحديات وبمظاهر التخلف ومعوقات تحول إلى إحداث أي بناء حقيقي وتغيير باتجاه التقدم وبناء مجتمع مدني ديمقراطي واعي بحقوقه وواجباته .
لذلك نجد الحكام والطبقات السلطوية؛ في هذه المجتمعات المتخلفة؛ يتشدقون باسم الحرية.. والديمقراطية.. وحقوق الإنسان.. لتنفيذ أجنداته الخاصة من خلال الأحزاب راديكالية.. وميلشيات مسلحة.. أو زعماء مستبدين.. ورجال سلطة انتهازيين.. يلعبون بأوراق الديمقراطية لتمرير صفقات مشبوه في استغلال ثروات المجتمع؛ بما يستشرى في هذه البلدان من بلدان العالم الثالث من مظاهر الفساد.. وانحلال الأخلاق.. والحكم الرجعي.. وغياب القانون.. وهم في هذه الدول التي يحكمونها عبر هذه الوسائل المنحرفة يوقعون مع دول العالم باتفاقيات المتعلقة بالديمقراطية وبحقوق الإنسان، بكون الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية هو عمل طوعي؛ لذلك فهم يترجمون التصديق أو الانضمام كواجهة إعلامي لهم في الساحة الدولية دون الوفاء بالتزامات المنصوص في بنود حقوق الإنسان أو القيام بواجبات إزاء ذلك، لان ما يجري في داخل بلدانهم هو بعيد كل البعد عن هذه الحقيقة ومضمون هذه الاتفاقيات؛ بما يتخذونه من الإجراءات والتدابير قمعية وتعسفية واستغلال السلطة تتماشى مع سطوتهم للسلطة وقمع الشعب .
وللأسف فان (الأمم المتحدة) في مراجعاتها لآليات مجلس حقوق الإنسان تغض النظر عما يحدث في هذه الدول، وان التقارير التي تصل إليهم بما يتعلق في إعمال حقوق الإنسان تركن جانبا وتبقى منسية فوق الرفوف، لان اغلب التقارير.. وعمليات الرصد.. وتوثيق.. أصبحت عند هذه المنظمة الدولية عملية روتينية لا تقدم ولا تؤخر من شيء، لان ما يقدم ويكتب في هذه التقارير من البلدان هم أفراد المجتمع المدني؛ فهم يلعبون دورا محوريا في رصد وتوثيق حال حقوق الإنسان؛ ولأكن منظمات المجتمع المدني في البلدان التي انظمها دكتاتورية وسلطوية يقعون تحت ضغوط ويتعرضون لشتى أنواع الابتزاز والتهديد بما يعيق عملهم بشكل حرفي وبما يجعل دورهم غير فعال ولا مؤثر في الحياة العامة في هذه المجتمعات.
ومع كل ما يحدث داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان من معوقات حقيقية تواجه عملها الرصين وخاصة في الدول الرجعية والدكتاتورية وفي بلدان العالم الثالث؛ إلا أنها تواصل العمل الجاد للحد من مظاهر الفساد في هذه الدول والعمل على ضمان محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان؛ وضمان عدم إفلاتهم من العقاب وخاصة في القضايا الشائكة، لان (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) الذي جاء عام 1948 والذي جاء تأكيد عليه عام 1993 في (مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان) بـ(( أنه من واجب الدول تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بغض النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية))، لذلك فان هذه الحقوق غير قابلة للتصرف ولا يمكن سلبها من الإنسان إلا في حالة المخالفات القانونية التي يرتكبها الفرد بحق الآخرين ويسلب حق الحياة منهم .
لذا فان سيادة القانون أمر في غاية الأهمية لكل شعوب العالم ودولها وواجب الحكومات فيها إخضاع جميع المؤسسات والجهات المسؤولة؛ العامة والخاصة؛ إلى المساءلة وفق قوانين الدولة والتي تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ وبمراقبة الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان التي يجب إن تتواجد في كل دول العالم كإحدى آليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان التي من صميم واجباتها متابعة ومراقبة أداء مؤسسات الحكومية لضمان حماية حقوق الإنسان، وإضافة إلى هذا الدور؛ فإنها تقوم بالتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد والمجتمعات ليتم تحسين الوعي المجتمعي بما يتماشى ويحسن من العادات والتقاليد الموروثة السلبية وخاصة بما يتعلق بالعادات والتقاليد حول (المرأة) ووظيفتها الاجتماعية والتي يحصر دورها ضمن إطار الإنجاب.. والعمل المنزلي، حيث في هذه المجتمعات يهيمن عليها (الرجل) بما يجعل الحقوق بين الجنسين متفاوتة وغير متساوية، وهنا وفي هذه المجتمعات يتطلب وضع رؤى وتصور لتغيير هيمنة (الرجل) على (المرأة)؛ وذلك بالتثقيف والتوعية بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية؛ باعتبار إن الجميع متساو في الحقوق مهما كانت جنسيته ودون تميز؛ والاعتراف بالتنوع الثقافي.. والاجتماعي.. والديني.. والعرقي.. والقومي.. وبتعدد الطبقات الاجتماعية.. ومستوى المعيشة.. باعتبار هذا التنوع جزء من الفسيفساء المجتمع في كل الدول والمجتمعات وأينما كانوا في مدن.. أو القرى.. أو الأرياف؛ وهذا التنوع هو بمثابة جزء لا يتجزأ من التنوع الثقافي والحضاري؛ والذي يجب على كل المجتمعات البشرية المحافظة عليه دون تمييز.. أو إقصاء.. أو تهميش.. وهذا ما يجب إن يؤخذ بنظر الاعتبار كواجب مفروض تشريعه من قبل المشرعين لضمان حقوق متساوية لكل إنسان يعيش على هذه الكوكب؛ وعلى الحكومات والسلطات الدول دعم وتنفيذ القوانين بالعدل؛ وضمن أيطار حقوق الإنسان وضمان تطبيقه العادل والمنصف وفي كل مجالات الحقوق الاجتماعية.. والثقافية.. والسياسية.. والاقتصادية.. وضمن مبادئ حقوق الإنسان من المساواة.. والعدل.. والحرية.. وعدم التمييز؛ وهذا ما يتطلب من إعمال الهيئات لحقوق الإنسان إيجاد بيئة مواتية وتمكينية وملائمة بما تواكب مع طبيعة بيئة هذه المجتمعات ليتم تعزيز حقوق الإنسان وضمن الأطر والمؤسسات القانونية ليتم الوصول إلى (العدالة الحقيقية) التي أقرتها المنظمات الدولية و(الأمم المتحدة) وتطبيق هذه (العدالة) على الجميع وعلى كل أصعدة الحياة .