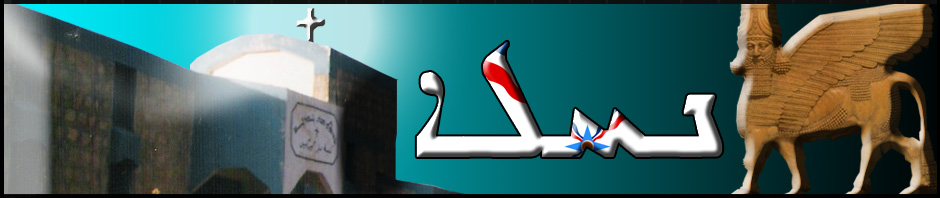بقلم آشور بيث شليمون
ܗܓܪܝܬܐ – الهاجرية
01 / 02 / 2015
http://nala4u.com
Patricia Crones & Michael Cook , HAGARISM , The Making of the
Islamic World- CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS – LONDON 1977
ملاحظة: لقد استشهدت من هذا الكتاب كثيرا في مقالاتي وخصوصا عند الدفاع عن القومية الآشورية – آشور بيث شليمون
……………
نبذة من هذا الكتاب بما يخص شعبنا الآشوري وفي بلاده الآشورية.
فقد اتسع العراق ليس لهوية إقليمية واحدة، بل لهويتين، هما الآشورية والبابلية. لقد عانت الثقافتان على حد سواء، طبعاً، من تدمير عنيف عند سقوطهما قبل الغزوات العربية بألف سنة: فكما حوّل نابوبالاسر والميديون آشوريا إلى «ركام وخرائب» عام 612 ق.م(64)، كذلك فقد دكّ أحشورش أسوار بابل، جرّد مواطنيها من أملاكهم وحوّل إلهها إلى سبيكة ذهبية وذلك بعد ثورة 482 ق.م(65). مع ذلك فقد بقيت الهويتان على حد سواء، الأولى تحت حماية درع مسيحي، والثانية تحت حماية درع وثني.
كان هذا التقسيم غير العادي للعمل بين المسيحية والوثنية نتيجة الأثر المختلف للحكم الأجنبي على الإقليمين. فآشور، التي لم يكن لديها الثروة الخرافية ولا الأهمية الإستراتيجية التي لبابل، تركت وشأنها فعلاً من قبل الأخمينيين والسلوقيين(66) ؛ ولأن العالم الخارجي حكم عليها بالنسيان، فقد استطاعت أن تعيد تجميع ماضيها المجيد بنوع من الهدوء(67). وهكذا فحين عادت المنطقة إلى بؤرة التاريخ في ظل حكم البارثيين، فقد عادت بتعريف آشوري للذات، وليس فارسياً، بغض النظر عن اليوناني؛ أُعيد تجديد معبد آشور، وأعيد بناء المدينة(68)، وعادت إلى الوجود دولة خلافة آشورية على هيئة مملكة أديابين التابعة(69). وضع الساسانيون حداً لاستقلال هذه المملكة(70)، لكنهم لم يستبدلوا الحكّام المحليين بطبقة بيروقراطية فارسية: مع أن مكانتهم أُنْقِصت بحيث أصبحوا خدماً مطيعين للشاهنشاه، وبالتالي استمرت موجودة طبقة أرستقراطية وطنية(71). مع ذلك، ففي هذا الصدد، كان موقعهم في الدولة الفارسية غير مريح. ففي ظل حكم البارثيين راح الشاهنشاهات يطالبون بوحدة دينية ردّاً على الأهمية السياسية(72)؛ أما في ظل حكم الساسانيين فقد فعلوا ذلك على نحو منظم، وفرضوا بالتالي حقيقة فارسية على الهوية الآشورية. وطالما كان مستوى الإندماج متدنياً أُمْكِن تغطية هذا التنافر بمحاولات توفيقية(73)؛ لكن ما أن وضع الساسانيون الطبقة الأرستقراطية المحلّية في تماس أقوى مع البلاط الفارسي، حتى أُغْلِقت عيون الشبكة(74). وهكذا فقد عملت مَلَكية فارسية من أجل إله إثني في الشرق ما عمله إله إثني من أجل ثقافة يونانية في الغرب، تمسّك الآشوريون بنسبهم، لكنهم بعكس أقاليم الغرب لم يكن باستطاعتهم أن يتهرطقوا فحسب: فحتى زرادشتية هرطوقية ظلت من منظور مفاهيمي فارسية، لذلك كان الآشوريون بحاجة مقابل الفرس إلى ديانة مختلفة بالكامل(75). من ناحية أخرى، فحتى مسيحية أرثوذكسية ظلت مجرد يونانية بالتداعي، لذلك فمقابل الإغريق تبدو هرطقة ما وكأنها تفي بالغرض. وهكذا، بعد انعطاف عبر اليهودية، تبنى الآشوريون المسيحية ووجدوا هرطقتهم في النسطورية(76).
كان هنالك بالتالي نسختان متمايزتان عن المسيحية في الكنيسة النسطورية: فمن ناحية كنيسة آشوريا المحلية، وهي تأكيد شوفيني على هوية ريفية؛ ومن ناحية أخرى كنيسة فارس الحضرية والتي كان مركزها في بابل، وهي تأكيد كوزموبوليتاني على حقيقة أممية. لكن إذا أُمْكِن مقارنة كنيسة آشوريا في هذا الصدد بالكنيسة المصرية، فشوفينيتها أخذت شكلاً مختلفاً إلى حد ما. فقد احتفظت مصر بإثنية ولغة مميزتين لها ضمن طبقتها الفلاحية، في حين كانت طبقتها الأرستقراطية تنتمي إلى العالم الهليني الأكثر اتساعاً؛ آشوريا بالمقابل امتلكت طبقة أرستقراطرية مميزة لها، في حين شاركت العالم الآرامي الأكثر اتساعاً في إثنيتها ولغتها. وهكذا ففي حين كانت الشوفينية القبطية إثنية ولغوية، استدارت شوفينية آشوريا إلى ذكريات ماض مجيد. في هذا السياق فإن اهتدائين جاءا في الوقت المناسب أفادا في تنقية الملوك الآشوريين من سوء سمعتهم حيال الكتاب المقدّس. الأول هو سردانا، ابن سنحريب، الملك الثاني والثلاثون لآشوريا بعد بيلوس وحاكم ثلث العالم المأهول، والذي أذعن لرسالة يونان التوحيدية وشرّع صوم نينوى الذي أنقذ نينوى من الدمار(86) ؛ وبما أن الصوم أنقذ الآشوريين من غضب الرب في الماضي، فقد أعاد تشريعه سابريشو من كرخا دي بيت سلوخ لإنقاذهم من الوباء بعد ألف سنة(87).و الثاني هو إعادة تحرير نسخة اعتناق إيزاتيس الثاني الذي من أديابين اليهودية في نسخة اعتناق نارساي الآشوري المسيحية(88). كان هذا يعني أن الآشوريين كانوا موحدين قبل المسيح ومسيحيين بعده، والماضي بالتالي قاد نحو الحاضر دون أي شرخ. وهكذا فتاريخ كارخا دي بيت سلوخ يبدأ بالملوك الآشوريين وينتهي بالشهداء الآشوريين: سركون أسسه(89) والشهداء جعلوه «حقلاً مباركاً للمسيحية»(90). يشبه ذلك أنه في القرن السابع قبل المسيح وقف العالم كله مرعوباً من ساردانا(91)، وفي القرن السابع بعد المسيح احتل القديسون مكانه باعتباره «شمس آثور» و «مجد نينوى»(92).
بالمقابل، فالكنيسة في بابل، لم تكن تمتلك فخار مصر اللغوي والإثني ولا فخار آشوريا التاريخي. وبالمقارنة مع مصر فقد حددوا هويتهم كأغيار(93) واستخدموا الفارسية والسريانية على حد سواء(94). وبالمقارنة مع آشوريا، فقد تخلّوا للوثنيين عن الماضي البابلي: فنمرود، الذي هو في آشوريا أحد الأسلاف من الملوك والذي كانوا يحتفلون بذكراه تحت أسماء القديسين المسيحيين(95)، احتُفِظ في بابل بمماثلته مع زرادشت(96) فأضحى إما مرفوضاً كمؤسّس للوثنية الفارسية(97) أو اُدْخل في حل استرضائي باعتباره المرشد الذي يوحى إليه والذي قاد المجوس في البحث عن المسيح(98)؛ لكنه في كلا الحالتين ظل غريباً. كذلك فبقدر ما أن التقليد الذي مثله ايشوداد المسيحي الذي من مرد يبدو مفصولاً بالكامل عن الماضي البابلي، رغم ضخامة تعاليمه، بقدر ما أن التقليد الذي يمثله ابن وحشية يبدو في علاقة حب كاملة مع الماضي البابلي، رغم ضخامة أخطائه.
مع ذلك فقد اختلفت الكنيستان الآشورية والبابلية على حد سواء عن كنيسة مصر في توجههما الأرستقراطي؛ الأولى لأن هويتها الآشورية أُلْبِسَت ثوب أرستقراطية وطنية، والثانية لأن الإنفصال عن هوية وطنية سمح لها بقبول كامل للقيم الأرستقراطية الفارسية. وهكذا فنبلاء الكنيسة الآشورية هم الذين كوّنوها: التسلسل اللانهائي للفلاحين في أقوال آباء الكنيسة المصريين يفسح المجال هنا إلى تسلسل لا نهائي لعلّية القوم في أعمال الشهداء الفرس، وفي حين أن عليّة القوم المصريين لم يستطيعوا افتداء مكانتهم الدنيوية إلا بالمضي نحو المونوفيزية،
فالمصادر النسطورية تطفح فعلاً بالإقرار الشرعي بالطبقة الأرستقراطية(99). إن خوف آشوريا على نمروداتها أو سنحاريباتها المحليين مقترن باجلالها الحضري للسلالة الملكية لأي سابا، يوحنان، أو غوليندخت(100)، والنساطرة بالتالي كانوا متوحدين في تقديرهم العالي للسلطة، الثروة، وللشهرة الدنيوية(101). والواقع أنه من حين لآخر كان تعصّب الشاهنشاهات يحول دون العمل في البلاط الملكي(102) ؛ مع ذلك فالأقطاب المحليون استطاعوا البقاء في السلطة، كما لعب العلمانيون دوراً بارزاً في الكنيسة النسطورية، أما الشاهنشاهات المتسامحون فقد كانوا يتلقون الخدمات الطوعية لمواليهم المسيحيين(103)؛ من بين كل العلمانيين نجد يزدين الكركوكي الموظّف الأميري المسؤول عن الضرائب والجزية والغنائم لخسرو الثاني، والذي كان مبجلاً باعتباره «المدافع عن الكنيسة بطريقة قسطنطين وثيودوسيوس» (104). وهكذا فالنساطرة كانوا متشابهين في اتحاد موقفهم من الملك الفارسي: فالجميع قبلوا بالتفوق السياسي للإمبراطورية الفارسية، وحتى الآشوريين لم يكن باستطاعتهم أن يأملوا بإعادة إحياء سنحاريبية؛ لكن ما أثار حنقهم كان تعصب الزرادشتية الإثني، لذلك فقد كان هدفهم هداية الشاهنشاه إلى المسيحية وليس الإنفصال عن حكمه(105).
كأعضاء في كنيسة أرستقراطية كان النساطرة يختلفون أيضاً عن الأقباط في امتلاكهم لثقافة علمانية غنية: فتقديرهم الرفيع للسلطة الدنيوية كان مقترناً بتقديرهم الرفيع للعقل البشري،وهي مسألة صادق عليها اللاهوت النسطوري. كان مرجعهم الرسمي، وهو ثيودوروس المصيصي، يعرف بالطبع عقيدة سقوط آدم التقليدية، والتي ترى حالة الخلود والمباركة الأولى قد عُطِّلت بالإثم وأفسدت على نحو تصاعدي وذلك حتى العودة الدرامية للنعمة مع الموت الخلاصي ليسوع. لكنه كان يعلّم أيضاً عن عقيدة أخرى تحكي عن حالة نقص أوّلية تقدّم الإنسان منها في ظل الهداية الإلهية حتى أُعيد اكتساب الخلود مع قيامة المسيح الأمثولية(106). وهكذا فقد أكدت العقيدة الأولى على حاجة الإنسان للنعمة، في حين أكدت الأخرى على قدرته على مساعدة ذاته: إذا كان للتوجيه الإلهي أي تأثير فالإنسان يجب أن يكون بالضرورة قادراً على التمييز بين الخير والشر وأن يعمل بما يمليه عليه عقله، ولذلك يجب أن يكون الشر فعلاً للإرادة وفعلاً ضد المعرفة الخيّرة(107). هذا الرأي الثاني هو الذي اختاره النساطرة، وإذا لم يمضوا في طريقهم نحو البيلاجية(108)، أو يختزلوا الفداء إلى مجرد رمز لخلود مستقبلي(109)، فهم حتماً عظّموا العقل على حساب النعمة(110).
لقد أدى امتلاك التفكير العلماني لملاذ آمن اجتماعياً وعقائدياً إلى أمرين بالنسبة للثقافة النسطورية. أولاً، في حين كانت الكنيسة القبطية ريفية جلفة، كانت الكنيسة النسطورية أكاديمية. بل إن أكثر ما يلفت النظر في المسألة، هو أنها دشنت واحدة من مدارس اللاهوت التي لا علاقة لها بالأديرة القليلة العدد في الشرق الأدنى وذلك حين هاجرت مدرسة الرها إلى نصيبين(111)، ونصيبين بدورها أوجدت سلسلة مدارس أخرى أصغر منها حجماً؛ كذلك فقد دشنت مدرسة ثانية مع استقرار سجناء الحرب في جنديسابور(112). وبشكل عام فقد تكرّر تأسيس المدارس الواحدة تلو الأخرى في حياة وجهاء النساطرة، والقليل من الأديرة كان دون مدرسة (113).
ثانياً، في حين رفضت الكنيسة القبطية الفكر اليوناني باعتباره فكراً وثنياً من الناحية الأخلاقية، فقد أضفت عليه الكنيسة النسطورية صفة شرعية باعتباره مسيحياً جاء قبل أوانه. لأنه لم تكن ثقافة آشورية تلك التي كانت تُعَلَّم في المدارس الآشورية: الإفقار الثقافي في آشوريا لم يكن أقل انتشاراً من الإفقار الثقافي في مصر، وكما كان الإرث المصري في الأدب القبطي محدداً بمقولات من القصص الشعبي، كذلك تماماً كان الإرث الآشوري في الأدب المسيحي محدداً بأحيقار، وزير الملوك الآشوريين(114). لكن بعكس الفلاحين المصريين، استطاعت النخبة الآشورية استعاضة ما فقدته بالحقائق الشاملة للفلسفة اليونانية. فهم لم يترجموا الفلاسفة فحسب بل مجّدوهم(115)، وفي الوقت المناسب صار النساطرة ماهرين في الفلسفة بما يكفي لأن يصدّروها إلى العرب من جديد(116).
في الوقت ذاته فإن مصير الرهبنة عند النساطرة كان بالتالي مختلفاً عن مصير الرهبنة بين المونوفيزيين. فقد بدأت مسيحية مابين النهرين كحركة رهبانية وفق الأنموذج السوري، مع كنيسة أبرشية مكّونة من «أبناء العهد»(117) المنذورين. لكن كما وجد القبط أن باستطاعتهم أعادة بناء مصر المقدسة في الصحراء، كذلك تماماً وجد الآشوريون أن باستطاعتهم إعادة خلق صورة لنظام حُكْمهم حول طبقتهم الأرستقراطية. لذلك يبدو مفاجئاً، أن النظام النسكي قد استؤصل بالفعل، وذلك مع تبني العقيدة النسطورية: لم يبق من «أبناء العهد» إلا الاسم(118)، فألغيت عزوبة رجال الدين(119)، ولم تعد الرهبانية تحظ بالتشجيع(120). بالمقابل فحين عادت النسكية في نهاية الأمر، كانت في شكل جديد ومختلف. وكما في مصر، فقد نُظِّمت الرهبانية وفق الأنموذج الباخومي؛ مع ذلك فمقارنة بمصر كان الرهبان لا يمثّلون سوى مرحلة إعدادية في المسيرة الروحانية. وكما في سوريا، فإن النساك هم الذين حافظوا على فخار المكان؛ مع ذلك فمقارنة بسوريا كان سبب وجودهم إيفاغرياًEvagrian (121). وهكذا لم يكن لدى العراق كيبوتزيم: لم يكن النساطرة ينفرون من السكن في الصحراء، لكنهم كانوا يفعلون ذلك بسبب العزلة التي تصاحب هذا السكن، وليس كي يزرعوا الزهور في الرمال. لكن بالمقابل، لم يكن لدى العراق قديسون عموديون: فالنساطرة لم يكرهوا إماتة الجسد، لكنهم كانوا يفعلون ذلك ليعفوا أنفسهم من الخدمة الكهنوتية المرهقة بسبب متطلباتها التي لم يكن لديهم لها وقت ولا تفكير لأنهم كانوا يلاحقون الرؤيا السرانية لله، وليس لمعاقبة الجسد على خطاياه(122).
بالمقارنة مع مصر وآشوريا فإن إقليم سوريا المتشظي لم يمتلك قط لا هوية ولا هويتين، وعوضاً عن ذلك كان مشكّلاً من مجموعة وحدات دقيقة سياسية، إثنية ودينية. ما من أحد كان يتذكّر في مصر تلك الأيام التي كان فيها لكل ولاية ملك، أما اللقب الفرعوني فلا يُذكّر إلا بأن البلد كانت ذات يوم مملكتين؛ بالمقابل ففي سوريا كان الجميع يعرفون أنه، قبل أيام أغسطس، كان لكل مدينة، وعملياً لكل قرية، ملكها الخاص بها(123). كذلك فقد كان لمصر اثنيتها الوحيدة والفريدة، لكن سوريا كانت مقسّمة بين الفينيقيين، الآراميين، اليهود، الكنعانيين، العرب، إلخ؛ وفي حين كان لمصر ديانتها الوحيدة والفريدة، كانت تعددية الملوك المحليين في سوريا مقترنة بتعددية بعليم (جمع بعل)محليين.
إن تأثير الغزو الغريب على مجموعة الهويات ذات النطاق الصغير هذه كان مدمّراً. فمن ناحية لم يكن ثمة فرعون سوري للأنباط أو لزنوبيا كي يستردوه، أو للسلوقيين وللرومان كي يرثوه؛ وحب الهلينية بالنسبة للإثنين الأولين يقترن بفشل الإثنين الآخرين في إدامة أي بنىً سياسية محلية(124). ومن ناحية أخرى لم يستطع الغزاة ترك الريف وشأنه. وبعكس البطالمة الذين استطاعوا حكم مصر باسكندرية ضد ممفيس وبطليماس ضد طيبة، كان على السلوقيين أن يبنوا مدينة لكل ملك مدينة؛ وحين استطاعت الهوية الوطنية لمصر أن تهدّد باستيعاب اليونانيين، لم تستطع إثنيات سوريا الوطنية سوى أن تخسر كياناتها الفردية لتبزغ كإثنية آرامية مقابل اليونانيين. وهنا كما هناك، حافظ الكهنة على وجودهم. لكن بسبب السمة المتشظية للتقاليد التي كانوا يمثلونها، وتعرضهم الكامل للهلينية، فقد كانت قدرتهم على حفظ الهوية الوطنية بالضرورة محدودة جداً. فمن منظور ثقافي، لم يكن ثمة مانثو Manetho أو بيروسوس Berossus سوري: وفيلون الجبيلي، الذي دوّن التقليد الفينيقي، لم يكن كاهناً محلياً بل أنتيكياً يكن حباً هلينياً للعلوم السرية الشرقية(125)؛ في حين أن هليودوروس، الذي ربما كان كاهناً في حمص Emesa، كتب كروائي يكن حباً هلينياً للعجائب الشرقية(126). من الناحية السياسية، لم يكن لدى الكهنة السوريين ما يحاربون لأجله أو يبكون عليه: فأورانيوس انطونيوس الذي صدّ الفرس بالحمصيين المحليين، لم يكن ايزودورس الذي حارب الرومان بالبوكولوي boukoloi(127) المحليين؛ في حين أن جوليا دومنا كانت تطمح إلى صنع أباطرة رومان، وليس ملوكاً سوريين، تماماً كما أن نوستاليجيتها كانت للوثنية اليونانية عموماً، وليس لطقوس حمص المقدسة على نحو خاص(128).
وهكذا اختفت أشكال الحكم الوطنية ليس فقط مادياً، بل أيضاً أخلاقياً: فكما استطاع إيونوس Eunus الذي حمسته الإلهة سيرا Dea Syra كي يحارب من أجل حريته الشخصية في صقلية الرومانية القديمة أن يعلن أنه ملك هليني ليس إلا(129)؛ كذلك تماماً فإن ثيودورتيس الذي ألهمته مسيحيته كي يدافع عن استقلاليته الثقافية في أواخر العصر الروماني في سوريا استطاع استعمال الملوك الفينيقيين ليزعم فقط عن امتلاك سابق لحقيقة يهودية(130). وحدها الرها، التي حافظت على استقلال متقلقل وفق الأنموذج الآشوري حتى عام 216، حافظت على ذكرى ملوكها المحليين(131)؛ وفي حين كانت اديابين حكومة خلافة آشورية، فإن اوسرهونة Osrhoene لم تكن مملكة متياني شاحبة(132). لكن من كان السكّان الآراميون لمدينة يونانية محكومة من سلالة ملكية عربية بين فارس وروما، حين هم بلا ماض(133)؟ لقد اختفى ملوك المدن وذكرياتهم بالضرورة من أرض البشرعلى حد سواء، ومعهم اختفت الهويات التي أُضِفيت عليهم. وظل إقليم مصر الروماني كيمه Kème، فكيمه هي التي حافظت على وجود الغزو الغريب، لكن فينيقيا كانت مجرّد إقليم روماني، فسوريا كانت النتاج لغزو أجنبي(134).
………………..
* الهاجرية كتاب من تاليف كل من الأساتذة باتريشيا كرونة ومايكل كوك وترجمة الكاتب السوري نبيل فياض.
النص هذا هو من فصل السابع تحت عنوان ” أقاليم الشرق الأدنى ” من الصفحة ( اللغة الإنكليزية ) 55 الى آخر صفحة 61 إلا فقرة واحدة .
آشور بيث شليمون