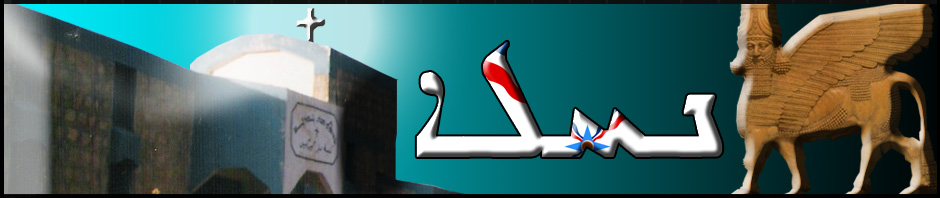بقلم جورجينا بهنام
من أين لنا بنوح جديد؟
20 /01 / 2013
http://nala4u.com
حاز الماء اهتماما وتقديسا واسعين من الجنس البشري عبر التاريخ، وكانت له مكانته وقدسيته لدى الحضارات الموغلة في القدم، سيما الحضارات التي نشأت في الأساس على ضفاف الأنهار، كحضارة وادي الرافدين في العراق القديم والحضارة الفرعونية في مصر القديمة والحضارات التي نشأت في الهند واليمن وسواهما. فقد أدرك الإنسان في وقت مبكر أهمية الماء في حياته ولعله حين شعر بالعطش لأول مرة، وروى ذلك السائل العجيب عديم اللون والطعم والرائحة غليله، عرف أن لا غنى له عنه، فشرع يقدسه ويتبرك به وبمصادره، وحين تطور به الحال وعرف الزراعة، بحث عن مصادر المياه ليستقر قربها ويؤسس حضارات عظيمة عرفت بأسماء انهار عظيمة، وأبتدع آلهة للمطر يدعوها فترويه ومحاصيله بأمطارها الغزيرة ويتوسلها لتبعد عنه خطر القحط والجفاف.
وتطور ارتباط الإنسان بالماء مع تطور معتقداته الدينية، فمازال المصريون يحيون عيد وفاء النيل حتى يومنا هذا بذات طقوسه التي تعود لسبعة آلاف عام، الا أنهم تخلوا عن العادة الفرعونية بإلقاء عروس خشبية في مياهه، وما برح نهر الكانج مقدسا لدى الهندوس يرومون ان يلقى رماد رفاتهم فيه فضلا على الغطس فيه تطهرا من الشرور، كما يرتبط الماء ارتباطا وثيقا بطقوس ديانات أخرى، ففي نهر الأردن اعتمذ السيد المسيح له المجد على يد يوحنا المعمذان (يحيى بن زكريا) وماانفك التعميذ متواصلا لدى المسيحيين وبنوع اشمل وأوسع لدى إخوتنا الصابئة المندائيين الذين يرافق الماء والغطس فيه طقوس الميلاد والزواج والوفاة لديهم.
ومع مرور السنوات والعقود والقرون وتقدم الحضارات من اختراع العجلة والري بالنواعير إلى الصعود إلى القمر والكواكب الأخرى التي وإن كان احدها من الماس الخالص لكنها خلت من اي أثر للماء حتى هذه الساعة. وما بينهما بنيت سدود وشيدت عليها محطات لتوليد الطاقة الكهربائية أساسها وجود الماء، فلم يفقد الماء قدسيته عبر السنين بل تبوّأ مكانة أعظم بعدما تعالت التحذيرات هنا وهناك من ان الحرب القادمة لن تكون من اجل النفط ولا طمعا بمزيد من الأراضي بل هي حرب المياه. وقد لاحت راياتها الاولى عندما بادرت دول الجوار لإقامة المزيد والمزيد من السدود العظيمة على روافد دجلة والفرات وما لحق مناطق عديدة من العراق من الجفاف إثر ذلك حولت نهرينا العظيمين الى ساقيتين يمكن عبورهما خوضا على الأقدام، وما لحق نهر الوند الذي يشق خانقين، خصوصا، من جفاف مسحه عن الخارطة، لكن ربك بالمرصاد، فقيض لهذه المياه الهائلة المحصورة وراء السدود العملاقة ان تسري تحت الأرض وترفع منسوب المياه الجوفية في بلادنا التي عانت لسنوات من الجفاف وإنخفاض معدلات التساقط ما بين مطر وبرد وثلوج، فتعالت دعوات العراقيين المظلومين الى ربهم ليمطر عليهم من بركاته فكانت دعوة المظلوم التي لاترد…وفتحت السماء مغاليق خزائنها المائية وأغدقت على البلاد فيضا بلل الأكف الضارعة وغسل الوجوه الواجمة وافاض القلوب المتحجرة، ولكن..جاءنا الخير من حيث لم نحتسب فغرقنا في شبر ماء كما يقول المصريون، ربما في شبرين، حقا لقد غرقنا وكانت اولى زخات الخير سببا في غرق مدن الموصل و واسط وديالى ثم احالت المطرة الثانية، ليوم واحد فقط، العراق كله تقريبا الى بركة كبيرة وصل منسوب المياه فيها الى 55سم فوق مستوى سطح المنزل، وصارت بلاد النهرين بلاد الأنهار وبات كل شارع فيها رافدا لدجلة والفرات واستحال البلد الى فينيسيا جديدة لاتنقصها الى الجندولات بعد ان استحال التنقل بوسائل النقل البرية. وفاضت مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك واليوتيوب وغيرها بصور مفزعة للضيف الذي دخل المنازل غير مرحب به، واتلف ما تبقى للفقراء من فرش ومؤونة حتى ان عوائل كثيرة قضت لياليها على اسطح منازلها هربا من الغرق، وحوصر المعتاشون يوما بيوم في منازلهم دون عمل ولا مصدر رزق لان الامطار التي هطلت ليوم واحد حاصرت مياهها، بالتعاون مع مياه المجاري الطافحة، المواطنين اكثر من اسبوع وأبت ان تبارحهم قبل تحيل انظارهم الى الجانب الايجابي، علَّ هذا الشعب الذي ما انفك يطالب بالخدمات يعي قيمة ان تتحول صالة منزله الى مسبح مغلق، او يحل الجاكوزي عوضا عن غرفة نومه فيعي المستوى الراقي الذي وصلت اليه الخدمات إذ ربما يبدع في استغلال هذه الثروة المائية لتوليد الكهرباء التي طالما تباكى عليها.
حين فاض نهر دجلة عام 1954 قبل اكثر من نصف قرن من الزمان، كان ذلك حدثا جللا عملت الحكومة بكل مفاصلها للتقليل من آثاره، وجادت معه قرائح الشعراء بقصائد غطت الحدث، وكانت اشهرها قصيدة نازك الملائكة التي شبهت فيضان النهر بالحب الجارف الراغب بطبع قبلاته الطينية على خدود محبيه، فأين قرائح الشعراء اليوم مما حصل في بغداد والحب الذي طغا متجاوزا القبلات الطينية بمراحل.
في تراث كل الشعوب وادبياتها نقرأ قصصا عن الطوفان العظيم المعروف بطوفان نوح، تحكي عن طوفان حصل بسبب طغيان البشر على الأرض، ورغم بعض الاختلافات في التفاصيل تبقى القصة شبه موحدة في ديانات ومعتقدات أمم كثيرة حول الأمطار الغزيرة التي أغرقت الأرض ومن عليها ولم ينج منها إلا ركاب الفـُلك العظيم.
وإذ يعتقد البعض أنها قصة من نسج الخيال او هي محض أساطير، أجرت بعثات تنقيب عن الآثار حفرياتها في بلادنا سعيا لتأكيد حدوث ذلك الطوفان العظيم كحقيقية تاريخية لا تقبل الجدال في حدود الألف الثالث قبل الميلاد، وبالفعل أكدت تلك التنقيبات حصوله، مستندين إلى اكتشاف طبقات سميكة من الغرين النقي تفصل بين آثار حضارتين في موقع مدينة اور الأثرية وعلى أعماق متباينة حيث سادت حضارات متعاقبة ثم بادت إذ تبين بأن تلك الحضارة ضربها طوفان رهيب وأن حضارات نشأت مكانها تدريجياً. وينقل عالم الآثار (ماكس مالوان) عن سير ليونارد وولي: (الطوفان هو الدليل الوحيد الممكن لهذا الطمي الهائل تحت التلة في مدينة أور، الذي فصل بين حضارتين).
ومع تواصل عمليات التنقيب تعرف العالم على قصة الطوفان السومرية كأقدم المصادر عنها، والتي تحدثنا عن ملك تقي أُخبـِر بالقرار الذي أعده مجمع الآلهة بإرسال طوفان عظيم ترافقه العواصف والأمطار التي استمرت سبعة أيام وسبع ليال، وحافظ ذلك الملك على الجنس البشري من الفناء ببنائه سفينة الإنقاذ. وعلى غرارها ما ورد في ملحمة كلكامش عن الرجل الذي أمرته الآلهة أن يحمل على سفينته بذور كل شيء حي، ومثلها القصة البابلية، لكن أشهرها هي قصة طوفان نوح الواردة في التوراة التي كانت تعد الأقدم قبل أن تستجد في التنقيبات أمور وأمور، الخيوط الأساسية في جميع القصص مشتركة، الرجل الورع يحمل تحذير الإله إلى البشر الذين استشرى بينهم الظلم والفساد، وفي قصة التوراة، اصطفى الله عز وجل نوحا التقي الورع ليبني الفلك العظيم ويحمل عليه زوجا من كل ذي جسد حي، مع أهل بيته، بعد ان يئس من أن يرد البشر عن معاصيهم إذ ملأوا الارض جورا وظلما. جاء في آيات سفر التكوين وهو السفر الأول من التوراة:
“فسدت الأرض أمام الله وامتلأت ظلما وجورا”. وقال الله لنوح” نهاية كل بشر امامي، لان الارض امتلأت جورا وظلما، فها أنا مهلكهم”.
الملاحظ أن المشترك بين جميع قصص الطوفان الدينية منها والأسطورية، أن الظلم والفساد الذي استشرى بين البشر وفساد الأرض بأهلها كان المحرك الأساس لفنائها بالطوفان أيام نوح (ع)، فربما يرى يقول قائل: إذن استحق اهل الغرب لشرهم وغواياتهم أن يقاصصوا بأعاصير (كاترينة) وأختها (ساندي) اللتين أغرقتا نيويورك وسواها وقطعت عنها الكهرباء وسائر الخدمات وأحالت حضارتها إلى خراب. وانتقام رب العالمين من الكفار اليابانيين الذين لا يعرفون الله هو سبب (التسونامي) الذي ضرب جزر اليابان وأغرقها، و هكذا ترى الزلازل لديهم لا أكثر منها، وكذا الحال في الفلبين والبرازيل وبريطانيا التي اغرقتها سيول وفيضانات في السنوات القليلة الماضية. فإن كنا نقيس الأمور بهذا المقياس بأي منظار ننظر إلى سيول جدة الشهيرة التي أغرقت المنازل ودمرت البنى التحتية في المملكة العربية السعودية، بل ماذا نقول عن الفيضانات التي اجتاحت فلسطين ولبنان والأردن وسوريا في الأيام القليلة الماضية مع إعصار “وضحة” (وهي تسمية للتندر أطلقها الأردنيون على المنخفض الجوي الأخير على عادة الأمريكيين إطلاق أسماء سيدات على الأعاصير، وسبقهم العراقيون بإطلاق اسم “هاشمية” على المنخفض الذي أغرق بغداد وسائر مدن العراق مع نهاية2012).
في مطلع الألفية الثالثة بعد الميلاد نستذكر الطوفان العظيم الذي وقع في مكان ما من بلاد الرافدين في الألف الثالث قبل الميلاد ونتساءل: إن كان شر البشر وظلمهم قد صعد إلى السموات أيام أبينا نوح واستوجب العقاب في غياهب الأيام، فهل ترتبط العواصف والأمطار الغزيرة والفيضانات في أيامنا هذه بذات الأسباب؟ وإن كان الصالح التقي البار هو المصطفى ليكون منقذ الجنس البشري من الفناء، فمن تراه المستحق ليبني لنا الفلك العظيم، ومن أين لنا بنوح جديد لينقذنا من الطوفان الجارف الذي أحاطنا بل أغرقتا أو كاد، قبل أن تفنى الأرض وأهلها بشرورهم؟
جورجينا بهنام
20/01/2013